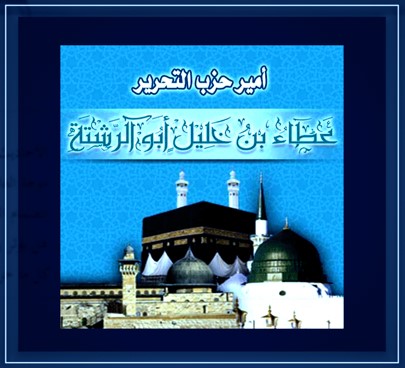مصر وخديعة حكم الشعب
الدكتور ماهر الجعبري*
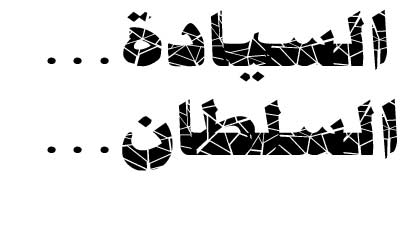 عندما وقف الرئيس المصري المنقلب عليه الدكتور محمد مرسي مستندا للمبدأ الديمقراطي يخطب معتدا يقول "الكلمة للشعب... لا معقب"، لم يخطر بباله حينها -على ما يبدو- أن الشعب سيقول كلمة أخرى، كما فعل في الاستفتاء على الدستور المصري الذي أعدّه الانقلابيّون.
عندما وقف الرئيس المصري المنقلب عليه الدكتور محمد مرسي مستندا للمبدأ الديمقراطي يخطب معتدا يقول "الكلمة للشعب... لا معقب"، لم يخطر بباله حينها -على ما يبدو- أن الشعب سيقول كلمة أخرى، كما فعل في الاستفتاء على الدستور المصري الذي أعدّه الانقلابيّون.
ولا زال على الطرفين -وضمن منظرّي الفريقين- من يدّعون "الشرعية" مستندين فيها لكلمة للشعب وحكمه، لا لأصلها الفكري والسياسي، بينما يتناسون أنهم أمام كلمتين للشعب في مصر، وأما "نَعَمَين" لدستورين مصريين، أعدهما طرفان متصارعان، يدّعي كلاهما وصلًا بالديمقراطية التي ألّهوا الشعب فيها وادعوا أنه مصدر الدستور. وهذه وقفة سياسية وفكرية أمام حكم الشعب وشرعيته:
في هذا السياق، يختلط مفهومان أساسيان في الحكم، وهما السيادة والسلطان. وإن كانت اللغة تحتمل شيئا من التداخل في المعاني بين المصطلحين، إلا أن العارفين بالفقه السياسي يميزون بين مفهوم السيادة ومفهوم السلطان، تماما كما يميّزون بين الحكم التشريعي والحكم التنفيذي.
إذ إن السلطان مقتصر على ما يتعلق بالحاكم في معناه التنفيذي، وبالجهة المخولة في تنصيب هذا الحاكم.
أما السيادة، فهي ببساطة امتلاك الحق في سن القوانين والتشريعات، وهي منسجمة في ذلك مع المعنى اللغوي الذي يشير إلى"المُقدم على غيره جاهاً أو مكانة أو منزلة أو غلبة وقوة ورأياً وأمراً". ولدى مراجعة الفقه السياسي (غربي النشأة)، يجد الباحث أن مصطلح السيادة يختلط فيه معنيان أحدهما يشير إلى تمكن الدولة من الحكم وممارسة صلاحيتها وتطبيق أحكامها، والآخر يتعلق بالتشريع، مما يعود في تأصيله الفكري إلى المفكر جان جاك روسو، عندما ربط السيادة "الشعبية" بالإرادة العامة. ولذلك صنّف المفكرون الغربيون نوعين من السيادة، هما:
- السيادة القانونية التي هي "السلطة القانونية المطلقة التي تملك –دون منازع- الحق القانوني في مطالبة الآخرين بالالتزام والخضوع على النحو الذي يحدده القانون".
- السيادة السياسية التي هي "القوة السياسية غير المقيدة أي القادرة على فرض الطاعة، وهو ما يستند غالبا إلى احتكار قوة الإرغام".
صحيح أن الدولة الدينية (في ممارسات أوروبا القديمة) قد جمعت السيادة والسلطان وأسندتهما لرجال الدين، وجعلتهم يشرعون وينفّذون بما ادعوه من استناد إلى حكم الله، ولكن الإسلام ميّز تماما بين السيادة والسلطان، وحسم الإسلام هذا الأمر عندما جعل السيادة للشرع تُستمد فيه الأحكام والقوانين من الوحي، بينما أبقى السلطان للأمة تختار حاكمها بملء إرادتها.
وهذه القاعدة الإسلامية راسخة في الثقافة الإسلامية تحت عنوانين رئيسين هما: الحاكمية والبيعة. ولذلك حصر مشروع دستور دولة الخلافة الذي أعده حزب التحرير، قواعد نظام الحكم في أربعة، اثنتان منها حسمتا هذه التفريق في هذه المسألة، بأن تخضع الأمة لأحكام الوحي بينما تمارس حقها في اختيار الحاكم وبيعته بالرضى.
أما مفهوم "الشرعية" الذي اقتحم الأدبيات السياسية العربية بعد الثورات، فهو أيضا مختلف ما بين الفكر الديمقراطي والفكر الإسلامي، فالشرعية برزت سياسيا كترجمة للكلمة الانجليزية(Legitimacy)، الذي يدور معناها حول مفهوم "الطاعة السياسية" والمرجع الذي يقبل فيه الناس النظام السياسي ويخضعون له.
ومن المعروف أن القوانين الوضعية (البشرية) مهما كانت الجهة المخولة بوضعها، لا تستند إلى جهة علوية تكسبها الهيبة أو "الاحترام" ومن ثم تفرض لها نوعا من الإلزام أمام الناس، فنشأت في الغرب "نظرية الشرعية" أو المشروعية لسد هذه الثغرة الأساسية. ومن ثم انجرّ وراء النظرة الغربية كثير من المثقفين "التوفيقيين"، ممن انشغلوا في التوفيق (أو التلفيق بالتعبير الأدق) ما بين النظرية الغربية والقاعدة الإسلامية، تحت وقع تقليد المغلوب للغالب.
ومن الواضح أن الشرعية -في السياسة الشرعية الإسلامية- لا تكون لنظام لا يُخضع الناس فيه لحكم الله في تشريعه، ولذلك لا شرعية دستورية بلا سيادة الشرع.
أما الشرعية بمعنى مشروعية لحاكم، فهي تتطلب أمرين اثنين هما: (1) تحقق اختيار الناس للحاكم (بأن يكون السلطان للأمة)، (2) تحقيق السيادة للشرع، بما يعني شرعية القوانين والأنظمة التي يطبقها الحاكم. فإن تم اختيار الحاكم بإرادة الشعب، وطبق حكم الشرع، كانت له المشروعية، وألزم الناس بالطاعة، وإلا فلا شرعية له ولا سلطان.
وعند إسقاط هذه المفاهيم على الواقع المصري، يتبين بوضوح أن الطرفين المتصارعين يخادعون الشعب في التلاعب بهذه المفاهيم، ويجنّدون من "العلماء" من يتغاضون عن أصل مفهوم "لا إله إلا الله" كمعبود ومشرّع، ويستسلمون لمفاهيم غربية أسندت السيادة للشعب (دجلا في واقعها). ثم يُسخّرون الشعب في الدفاع عن شرعية باطلة، إمّا من حيث إرادة اختيار الحاكم (كما في حالة تسلّط السيسي) أو من حيث تأليه الشعب في التشريع (كما في دستور مرسي).
ولا يمكن لأحد أن يدّعي أن الصراع على دستور 2012 ودستور 2013، هو صراع بين مشروع إسلامي وآخر علماني، لأن الدستوريين علمانيين بلا خلاف، ولا أظن أن ثمة عاقلا ادعى أو يدعي أن دستور 2012 كان إسلاميا لأنه وُضع (أو اُبتدع) تحت حكم "الإسلاميين".
إن المجاهرة الديمقراطية بأن "الكلمة للشعب.. لا معقب"، هي خروج عن المفاهيم الإسلامية الأصيلة، وهي أيضا تورط في "لعبة" سياسية ارتدت سلبا على من مارسها. ولا شك أن الدكتور مرسي يدرك السياق اللفظي الذي وردت فيه "لا معقّب" في القرآن الذي يحفظه، وذلك في قول الله تعالى "وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ"، كما يدرك ذلك المنظرون "الإسلاميون" الذين يكافحون لإرجاع دستور 2012 خلال الصراع لإبطال دستور 2013.
ليس ثمة من شك في فشل محاولات أسلمة الديمقراطية، وإرجاع التشريع للشعب من دون الله، على أساس التضليل بالشورى، والسياق القرآني الذي يرجع الحاكمية لله، لا يتعلق بالحكم التنفيذي (وحاشا لله أن يحكم تنفيذيا)، والإسلام لم ينصّب الحاكم بسلطان روحي من الله كما هو المفهوم في الدولة الدينية، إذن فالله يحكم كمشرّع، وإلى شرعه ترجع السيادة في الأحكام والدستور والقوانين.
ومصر اليوم، تثبت من جديد أن الديمقراطية بإرجاعها الحكم التشريعي للشعب، متناقضة في الأصل وفي التفاصيل وفي التطبيق (إن كانت الديمقراطية حقا قابلة للتطبيق):
فالذي صاغ الدستور هم مجموعة من العقول البشرية تواضعوا على ما يحقق "المصالح"، والسعي نحو المصلحة هنا ليس مقتصرا فقط على هذا الدستور المصري، بل هي حاضرة في كل صياغة بشرية عقلية للدساتير الوضعية.
ولا شك أن المشرّع البشري ينحاز تلقائيا إلى تقويمه هو للمصالح، وهو أيضا عاجز عن الإحاطة بكافة تفاصيل وتشابكات الأحكام، ومحدود النظرة –بل قاصر- في الحكم على ما هو حسن وما هو قبيح من الأفعال. ولذلك تظل الدساتير المصرية -قبل الثورة وبعدها وبعد الانقلاب- تسبح في وحل هذا التشريع البشري الباطل.
وعندما تدّعي الديمقراطية أن الحكم للشعب، فإن التجربة المصرية التي تابعها الناس على الفضائيات، تؤكد أن الشعب لا يحكم (بالمعنى التشريعي) إلا بمقدار الحبر الذي يبصم به على ما تفتقت عنه تلك العقول المصلحية.
صحيح أن الانقلابيين تجبروا وأجرموا في قمع الشعب من أجل إرجاع السلطان لقادة الجيش، وصحيح أن الدكتور مرسي لم يتمكن من ممارسة السلطان الفعلي خلال سنة حكمه وأنه اليوم منكل به من قبل الانقلابيين، فلا تستوي النظرة العاطفية تجاهه مع النظرة للمجرمين من بعض قادة العسكر، لكن الجانبين والدستوريين أصرّا على إعطاء الشعب (صوريا) ما لا حق له من تشريع، بينما يضللان في مشروعية الحكم بالاستناد إلى اختيار الشعب.
لذلك لا مخرج لمصر ولا لغيرها من بلاد المسلمين إلا بالجمع بين
1) إرجاع السيادة للشرع، ونفيها تماما عن الشعب وعن المشرّعين ممن ينصبهم الحاكم أو يختارهم الشعب.
2) انتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه وإرجاعه للأمة تختار حاكمها بالانتخابات لا بالتجبر العسكري.
عندها فقط تعود الأمة إلى أصالتها، ويعود لحضارتها بريقها، وتعود لمصر مكانتها في قلب العالم الإسلامي.
*عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين